
المقاومة المدنية في الموصل: حكايات مَن واجهوا “داعش”
مقدمة
استطاع تنظيم الدولة الإسلاميّة (داعش)، إبّان سيطرته على الموصل على مدى ثلاثة أعوام، أن يعمّق آلام الموصليّين، ويخلّف في مجتمعهم آثاراً مؤلمِة مِنْ حقبة معاناةٍ وإجرامٍ لا زالت معالمها ظاهرة حتى اليوم في حياتهم ويوميّاتهم وأحاديثهم، وبصورة أوضح في شوارعهم حيث يتكوّم ركام المباني في انتظار مَنْ يرفعه.
فمنذ أن سيطر هذا التنظيم على المدينة، في صيف العام 2014، وحتى انسحابه منها في نهاية العام 2017، ارتكب انتهاكات لا حصر لها، بدءاً من تقييد الحياة العامة والتحكّم بالحياة الشخصية ونسف الحريات وصولاً إلى الاعتقالات والتعذيب في السجون، وإلى الاغتيالات والإعدامات الوحشيّة في السرّ والعلَن، مودياً بما لا يقلّ عن عشرات الآلاف من القتلى المدنيين، إضافةً إلى ثمانية آلاف مفقود، ومُحَوِّلاً مئات البيوت والمعالم التراثيّة والحضاريّة إلى أنقاض، وذلك بحسب التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية.
هذا العنف المفرط الذي أبداه التنظيم، وما أدى إليه من كلفةٍ باهظة دفعتها الموصل، كان في جزء كبير منه موجهاً ضدّ الأصوات التي علتْ فيها ضدّ راياته السوداء وحاولت الوقوف في وجهه. ففي المقابلات التي أجريناها لإعداد هذا التحقيق، استطعنا أن نلمس مدى تَمَسُّك أهالي المدينة بهويتهم، واستحضارهم إيّاها في الحوارات والأحاديث والذكريات. ويمكن القول إن المجتمعات ذات العمق الحضاريّ مثل المجتمع الموصليّ، عندما تتعرض لغزوٍ فكريّ وعقائديّ، تتقدّم في سُلَّم أولويّاتها مسألةُ الحفاظ على هويتها الثقافيّة التي تلعب دوراً حيويّاً في تماسكها المجتمعيّ، وفي تعميق وعي الشخصيّة لِذاتها من أجل الحفاظ على خصوصيّتها.
والحال أنّ سكّان الموصل أبدوا أشكالاً متنوّعة من مقاومة “داعش”، بعناصره وأفكاره وقوانينه وعنفه، ولم تكن أهمية تلك المقاومة بوجودها العسكريّ المُسَلَّح، إنما في الدفاع عن الهوّية والخصوصيّة في وجه العقيدة التي سعى التنظيم إلى فرضها على الموصليّين، والتي أُريد بها، بما تحمله من أفكار وأخلاقيّات وممارسات، دَفْعُ المجتمع الموصلي إلى الاغتراب عن هوّيته وَسِماته التي تشكّلت عبر مئات السنين.
يسعى التحقيق التالي إلى دراسة معالم وأشكال المقاومة المدنيّة في وجه تنظيم الدولة إبّان سيطرته على الموصل، وإلى استكمال صورة المدينة في تلك الحقبة، والتي نشرت عنها آلاف التحقيقات والمقالات والتقارير الحقوقيّة، متناولةً مختلف جوانب العنف الذي مارسه التنظيم.
والجدير بالذّكر أنّ مُعدّ هذا التحقيق، وهو في الأصل من الموصل وقد عايش حقبة داعش، قد أجرى 18 مقابلة ميدانيّة في مدينة الموصل التي زارها من أجل إجراء البحث، فجالس السكّان وحاور الشهود في الأماكن التي كانت قبل عشر سنوات ترزح تحت أصوات القصف ويتسيّدها عناصر التنظيم.
ينطلق التحقيق في فصله الأول من سياق تاريخيّ حديث للموصل، يمتدّ على مدى عشر سنوات سبقت سيطرة داعش، فيسلِّط الضوء على البيئة التي عاش فيها السكان، والعوامل التي ولّدت عندهم وضعاً عاماً قلقاً وغير مستقر، ثم ينتقل إلى مرحلة سيطرة التنظيم عبر عرض المحطّات المرحليّة التي انتهت باجتياح المدينة في الأيام الأولى من حزيران/ يونيو العام 2014، والتي أعقبها تبلور الملامح الأولى لتسلّط التنظيم في المدينة.
أما في الفصل الثاني فيستعرض التحقيق نماذج متعدّدة من “ردّ الفعل” أو المقاومة التي أبداها سكان الموصل تعبيراً عن رفضهم سيطرة التّنظيم، مصرّين على رفض الواقع الذي فرض عليهم، وعلى كسره أيضاً. كما يتناول بعض الملامح القاتمة من الـ “فعل” الذي تُمثِّله مظاهر لا حصر لها من توحّش هذا التنظيم.
وتجدر الإشارة إلى أن النماذج التي يعرضها التحقيق عن المقاومة المدنيّة من جهة، وعن انتهاكات التنظيم من جهة أخرى، ليست إلا جزءاً يسيراً من تاريخ تلك السنوات الثلاث، إذ إنّ مئات القصص عن التّمرد وعن تحدّي نظام “داعش”، قد طُمِست في مقابر جماعية، وفي ذاكرة مُظْلِمة لا يرغب الكثير من الموصليين في نبشها.
صعود “داعش” وسقوط الموصل
شهد العام 2014 توسّع الرقعة الجغرافية التي يسيطر عليها مقاتلو “داعش” في العراق، بالتوازي مع سيطرته في سوريا على مدينة الرقة، وتمدّده إلى بعض المناطق في محافظات حلب ودير الزور وحمص وغيرها.
دخل التنظيم الموصل في حزيران/يونيو العام 2014، أي في أوجِ صعوده، بعد أن سيطر على مدينة الفلوجة في كانون الثاني/يناير العام 2014، وعلى مناطق أُخرى في محافظة الأنبار كما على تكريت، مركز محافظة صلاح الدين.
جمرٌ تحت الرماد
بالرغم من أنّ الموصل كانت في الظاهر تعيش حياةً طبيعية، قبل حزيران\يونيو العام 2014، فإنّ معظم سكان المدينة كانوا يتابعون بحذر الأخبار المتواترة عن هجمات تنفّذها جماعات مسلحة على دوريات ونقاط عسكريّة في المدينة، وذلك في ظلّ مشاعر غلب عليها القلق والارتباك، إذ كانت الممارسات الطائفية على يد السلطات الأمنيّة والعسكريّة التي تحكمهم، قد بدأت قبل عشر سنوات تقريباً.
شهدت الموصل الكثير من الاحتجاجات والاعتصامات المناهضة للسلطة العراقيّة الجديدة، خصوصاً بعد تكاثر حملات الاعتقال التي كانت تنفذها قوات الأمن، إضافة إلى شكوى الأهالي من تزايد حدّة الاحتقان الطائفيّ.
فقد بات من الشائع آنذاك، بحسب ما ورد في المقابلات التي أُجْرِيَت لإعداد هذا التحقيق، أنْ تقتحم القوّات الأمنيّة البيوت في ساعات الفجر الأولى وقبل شروق الشمس بحثاً عن أية قطعة سلاح حتى ولو كانت مرخَّصة. وإذا ما عُثِر على سلاح شخصيّ كان يُصادَر ويُعتقَل صاحبه، بموجب المادة الرابعة من قانون “مكافحة الإرهاب” الذي أصدرته الجمعية الوطنية العراقية في العام 2005، والتي تنصّ على إنزال عقوبة “الإعدامِ بكل من ارتكبَ بصفتِهِ فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الأعمالِ الارهابية، ويُعاقبُ المحرضُ والمخطط والممولُ وكلُّ من مكَّن الإرهابيينَ من القيامِ بالجريمةِ كفاعلٍ أصلي”، إضافة إلى “السجنِ المؤبدِ لكلِ من أخفى عن عمد أي عملٍ إجرامي أو تستَّرَ على شخص إرهابيّ”.
وبفعل هذا القانون شهدت محافظة نينوى، خلال الأعوام التي سبقت سيطرة التنظيم، اعتقال عشرات المواطنين الذين امتلأت بهم السجون الحكومية حيث كانوا يتعرضون للإساءات، كما تكاثرت نقاط التفتيش في المدينة مشكلةً هاجساً لأغلب السكّان.
يقول خليل صبري، أحد سكان الموصل: “كانت النقاط الأمنيّة (حواجز التفتيش) مصدر إساءات طائفيّة لفظيّة كثيراً ما تعرَّضنا لها على لسان عناصر الأمن الحكوميّة والجيش، وغالباً ما تكون الإساءة مقصودة إذا كان الشخص برفقة زوجته وأولاده، وإذا ما بدرت منه علامات الامتعاض، قد يتعرّض لإساءات لفظية وجسدية أشدّ وأقسى، لذا تفادى الجميع الإتيان بأي حركة أو ردّة فعل قد لا تُعْجِب عنصر الأمن الذي يدقّق في هويته، خشية أن تُهان كرامتهم”.
بلغ التوتّر الأمنيّ في المدينة درجاته القصوى بين العامَيْن 2006 و 2008، مع غياب أي تواجد فعليّ للسلطة العراقية، إذ لم تتعدَّ سلطة القوّات الأمنية منطقة الدواسة في الجانب الأيمن من المدينة، قرب مبنى محافظة نينوى، ومبنى مجلس المحافظة، إضافة إلى مديريّة الشرطة ومُجَمَّع المحاكم.
في كانون الأول/ديسمبر العام 2012، اشتدّ احتقان الشارع ضدّ القوات الأمنيّة، بعد أن اغتصب عنصرٌ في الجيش فتاة قاصراً، فانطلقت تظاهرات حاشدة أمام بوابة كلية “الإمام الأعظم” تطالب بخروج القوّات الأمنية من داخل الموصل. وتصاعدت بعد ذلك المظاهرات والاحتجاجات التي واجهتها الشّرطة بعنف بلغ حدَّ إطلاق النار عليها ومقتل بعض المتظاهرين، وهو ما استدعى تنديد بعض المنظّمات الحقوقيّة.
في موازاة ذلك، تزايدت هجمات التّنظيمات المسلَّحة الناشطة في نينوى على القوات الحكوميّة في الموصل. وفي 25 نيسان/أبريل العام 2013 أُعْلن حظر التجوّل فيها إثر هجوم من عناصر تنظيم الدولة الإسلاميّة على مراكز للشرطة والجيش العراقي في منطقتَي “17 تموز” و”الرفاعي”.
وفي أوائل العام 2014 كانت قد ترسَّخت سيطرة “داعش” ونفوذه في بعض الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة نينوى مثل البعاج وتل عبطة والمحلبية والقيارة، إضافة إلى مناطق أخرى في غرب وجنوب الموصل.
واللافت في هذه المرحلة هو أنّ سياسة التّنظيم في محافظة نينوى، لم تقتصر على هجمات خاطفة على النقاط العسكريّة والأمنيّة، بل توسّعَت إلى جمع الأموال عبر إتاوات فرضها على بعض المشاريع، وهو ما أشار إليه مدير استخبارات نينوى في حينه، اللواء أحمد الزّركاني، في جلسة استماع، في العاصمة بغداد، أمام “اللجنة التحقيقية النيابية الخاصّة بسقوط الموصل” في شباط/فبراير العام 2015.
ومّما ذكره الزركاني أنّه عند تولّيه مهامَّه، في مطلع تشرين الأول/أكتوبر العام 2013، عمل على تحديد التّنظيمات الناشطة في المحافظة، وكان أبرزها “تنظيم دولة العراق الإسلاميّة”، الذي كان آنذاك “مسيطراً على محافظة نينوى 100 في المئة” بحسب تعبيره، على اعتبار أنه كان “يأخذ إتاوات من كل الناس الموجودين في المحافظة، ومن المشاريع بطريقة أو بأخرى”.
في الخامس من يونيو/حزيران العام 2014 هاجم عناصر “داعش” مدينة سامراء التابعة لمحافظة صلاح الدين، فزاد التوجّس في الموصل من تعرّضها لسيناريو مماثل، ولذلك فرضت السلطات حظراً للتجول دخل حيّز التنفيذ عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه. وفي غضون الأيّام الخمسة التالية، سقطت المدينة كلّيّاً تحت سيطرة التّنظيم.
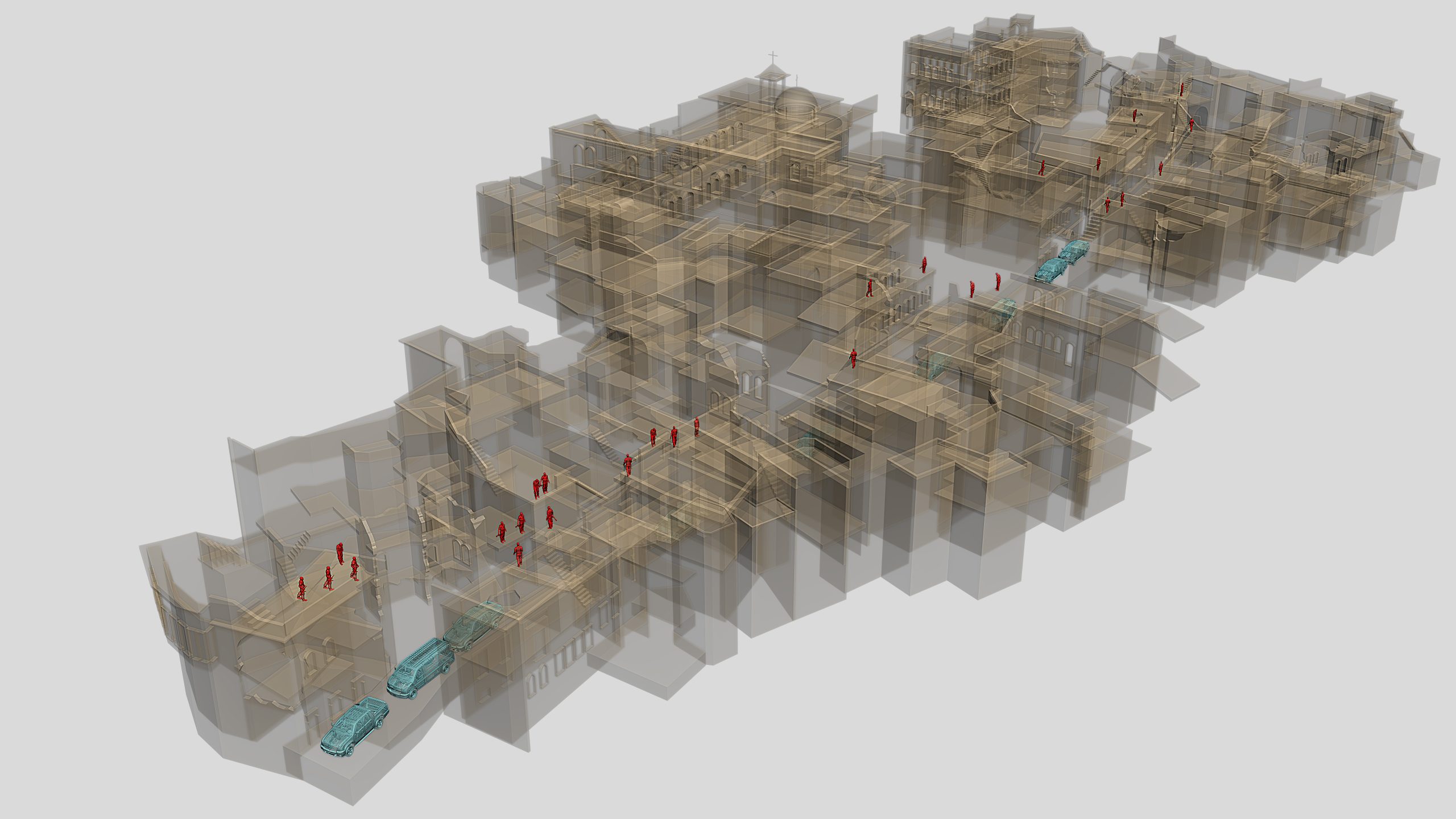
مراحل اجتياح الموصل في حزيران/يونيو العام 2014
- 5 حزيران/يونيو
فُرض حظر التجوّل كإجراء احترازي في كلّ محافظة نينوى، على أثر انتشار أخبار أفادت بانتشار مسلّحين على أطراف الجانب الغربي منها. وقد سادت حالة ترقب بين عموم السكان وسط صمت ثقيل قطعته أصوات إطلاق نار بين حين وآخر.
- 6 حزيران/يونيو
سيطر عناصر التنظيم على الأحياء الغربيّة من الموصل، (الهرمات والإصلاح الزراعي والنهروان والحي الصناعي وسوق المعاش وحي اليرموك)، وتمترسوا في الأزقة، وانتشروا على أسطح الأبنية العالية. وقد أبلغوا السكان بضرورة مغادرة منازلهم. ووسط صمت الإعلام الحكومي، نشر التنظيم على “تويتر” (موقع X حالياً) صوراً أظهرت مركباته وأعلامه في المدينة.
- 7 حزيران/يونيو
عزّز التنظيم سيطرته على الأحياء الغربية، وفجّر سيارة مُفخَّخة عند مقرّ مديريّة شرطة أم الربيعين بالقرب من مركز شرطة الشيخ فتحي، منهياً بذلك كلّ تواجد للقوّات الأمنيّة من الشرطة أو الجيش في حي النجّار.
في هذا اليوم وصل معاون رئيس أركان الجيش العراقي، عبود كنبر، وقائد القوات البرية، علي غيدان، إلى الموصل عن طريق المطار، ليتولَّيا قيادة عمليّات نينوى. استمرّ قصف الأحياء السكنية التي احتلها التنظيم بالهاون من الجانب الأيسر في المدينة، وبدأت حملة نزوح كبيرة. انتشر أهالي الموصل على الطرقات يوزّعون المياه والمشروبات الباردة ووجبات طعام خفيفة، وأقاموا عيادات طبية، ونقلوا كبار السنّ والمُقعدين والنساء بالسيّارات الحكوميّة.
- 8 حزيران/يونيو
أقيل مدير شرطة نينوى خالد سلطان العكيدي، وعُين خالد الحمداني بدلاً عنه، بينما كثفت مدفعيات الجيش قصفها على أحياء تموز والرفاعي والنجار وحاوي الكنيسة ومشيرفة، وواصل الطيران قصف تلك المناطق. أخلت الشرطة الاتّحادية أماكن انتشارها في حي العامل، وفي أطراف حي الإصلاح الزراعيّ، وعلى امتداد شارع بغداد، وبدأت بالتجمُّع في مقرّات الأفواج بعد إنسحاب المفارز والسرايا التي كانت تمثل العمود الفقري لخط الصدّ.
ومع تكثّف أعمال القصف اشتدّ النزوح وبلغ ذروته، وبرزت مشكلة الطالبات المتواجدات في الأقسام الداخلية في حرم الجامعة، وقد تعاونت عدة جهات لإجلائهن من الموصل، إلى سهل نينوى.
أمّا محافظ نينوى آنذاك، أثيل النجيفي، فقد دعا الأهالي إلى تنظيم صفوفهم عبر تشكيل لجان شعبيّة تمهيداً لتوزيع السلاح عليهم والشروع في المقاومة المسلحة، لكنّه، بحسب ما صرّح به لاحقاً، لم يتمكّن من الحصول على الموافقات الأمنيّة اللازمة لتسليح المدنيّين.
- 9 حزيران/يونيو
أخلت الشرطة الوطنية مواقعها في الأحياء الواقعة خلف خط الصدّ (الزنجيلي وباب سنجار والصحة والثورة ورأس الجادّة) قرب مركز المدينة، ما فتح الباب أمام عناصر التنظيم للعبور إلى منطقة الدوائر السياديّة مثل مركز المحافظة والبنوك وقيادة الشرطة وقيادة العمليات. وقد فجّر التنظيم صهريجاً عسكرياً عند فندق الموصل قاضياً بذلك على آخر ما تبقى من خطّ الصدّ. وقد أكّد محافظ نينوى أثيل النجيفي للإعلام إنّ المدنيّين العزَّل هُمُ الآن “في مواجهة مباشرة مع الإرهاب، وليس هناك أي خطط عند القيادات العسكرية المتواجِدة في المدينة”.
ومع ساعات النهار الأخيرة كانت مركبات التنظيم قد وصلت إلى مبنى المحافظة والبنك المركزي ومبنى قيادة شرطة نينوى، واندفعت قوة أخرى منه عبر دورة بغداد في اتّجاه الغزلاني ومقر قيادة عمليات نينوى، ولم تواجه أي مقاومة، إذ كانت كل هذه المناطق بحكم الساقطة حتى قبل وصول العناصر إليها.
يروي سكان من أحياء الضباط والفيصلية والزراعي، في شهاداتهم، عن “فرار” القوّات الأمنيّة وهم يقودون سياراتهم بسرعات جنونيّة، ويطلقون النار في الهواء، ويواصلون الهرب تاركين مركباتهم في مكانها إذا ما تعطّلت أو تعرَّضت لاصطدام.
- 10 حزيران/يونيو
تواصَل تدفّق القوات الأمنية الفارّة من الضفّة اليمنى لنهر الفرات في الموصل، إلى الضفة اليُسرى، ومنها إلى تلكيف (في شمال شرقي نينوى). ومع انهيار سيطرة القوات الأمنية بالكامل على الجانب الأيسر من النهر، غادر بعض المدنيّين أحياءهم بسياراتهم، الأمر الذي كان ممنوعاً منذ فرض حظر التجوّل. وفي ساعات النهار الأولى، كانت شوارع الموصل تكتظّ بخليط من السيارات المدنية والعسكرية الهاربة في اتجاه الطرق المؤدية إلى إقليم كردستان.
ومع شروق الشمس كان قد انتهى كلّ تواجد للجيش العراقي في الموصل، وباتت المدينة غارقة في الحرائق والدخان، وبدأت تنتشر فيها الرايات السوداء. ومع تقدُّم ساعات النهار، بدأ يتكشَّف لأهالي منطقة النزوح، في سهل نينوى وإقليم كردستان، حجم الكارثة والمأساة على مداخل مدنهم وقراهم. ولم تلبث أن فُتحت أبواب الكنائس والمزارات والمساجد، وقاعات الأعراس والمدارس، لإيواء النازحين.
وثيقة المدينة
عمد تنظيم الدولة، منذ الأيام الأولى لسيطرته على الموصل، إلى اللعب على وتر توجّس السكان من الممارسات الطائفية السابقة، فشرع في تطبيق سلسلة إجراءات، من أجل طمأنتهم، والتقرّب منهم. فراح عناصر التنظيم يتجوّلون في الشوارع بسيارات مكشوفة، وهم يدعون عبر مكبرات الصوت الموظّفين الحكوميين للتوجه إلى دوائرهم، كما أوعزوا بفتح المتاجر والمخابز ومحالات البقالة والمواد الغذائية، وبدت أسواق المدينة شبه طبيعية، بعد الأسبوع الأول من السقوط، إذ كان معظم السكان قد لازموا منازلهم.
فتح التنظيم الطرقات التي كانت مُغلقة لدواعٍ أمنية، وفكّكَ نقاط التفتيش، وبدأت في المدينة حملة واسعة لتنظيف الشوارع والسّاحات، إضافة إلى إعادة تأهيل الطُرقات المتضرّرة وتشغيل إشارات المرور، وعاد التيّار الكهربائيّ بعد أن كان يشهد انقطاعات طويلة. لكن ذلك المشهد لم يستمرّ طويلاً.
يقول خليل، وهو موظَّف حكوميّ في مؤسسة الكهرباء: “لم تلبَث أن بدأت دلائل التغيُّر تظهر على تصرّفات عناصر داعش. فقد غابت السياسة في تعاملهم مع السكان، وعمدوا إلى تطبيق ما ورد عندهم في ما أسموه “وثيقة المدينة”، وأقاموا نقاط تفتيشٍ عند المخارج والمداخل وبعض الشوارع الرئيسة، تماماً كما كانت عليه الحال طوال الأعوام التي سبقت السقوط.
وقد تضمنت “وثيقة المدينة” التي أصدرها التنظيم بعد ثلاثة أيام من إخضاعه الموصل، 16 (ستّة عشر) بنداً، تحوي ما يمكن تسميته بـ “العقد الاجتماعي” تبعاً لرؤيته، مقدِّماً قوّاته فيها كـ”جنود الدّولة الإسلامية في العراق والشام”، وملمِّحاً إلى السياسة التي سينتهجها في إدارة شؤون المدينة.

لم تلبث أن دخلت الوثيقة ببنودها حيّز التطبيق، وأبرزها التدخّل الشرس في سلوكيّات السكّان وعاداتهم، وتفجير المعالم التي تُشكل هوية المدينة في وجدان سكانها، فضلاً عن شنّ حملات اعتقال واسعة طاولت مختلف الشرائح، من أطبّاء وحقوقيّين ومهندسين وموظّفين حكوميين وعناصر الجيش والشرطة.
يعتبر سكان الموصل يوم الرابع والعشرين من تموز\ يوليو العام 2014، تاريخاً مفصليّاً، إذ انقشعت معه ضبابيّة المشهد في أذهان كثيرين منهم بعد سقوط مدينتهم. ففي ذلك اليوم فجّر عناصر “داعش” “مقام النبي يونس”، الذي يشكل أحد أبرز معالم المدينة، وتبعَ ذلك تخريب معالم مشابهة أبرزها، مقام “النبي شيت” وسط الموصل، ومقامات “النبي جرجس” و”النبي دانيال” و”الإمام يحيى القاسم”، إضافة إلى الكنائس مثل كنيسة “اللاتين للآباء الدومينيكان” (تُعرف محلياً بكنيسة الساعة) وكنيسة “مار توما” وكنيسة “شمعون الصفا” وغيرها.
الفعل ورد الفعل: المقاومة المدنية ضدّ “داعش” في الموصل
خلّفَت السنين الثلاث التي سيطر فيها “داعش” على الموصل ذاكرة موجعة عن جرائم بشعة ارتكبها بحق مئات الآلاف من السكان، حتّى أنّه، أثناء عملنا على هذا التحقيق، لم يكن من السهل علينا محاورة الأهالي وإعادة فتح صفحات ذاكرتهم، ومردُّ ذلك إلى عدم رغبة الكثير منهم في استعادة الماضي من ناحية، ولقناعة بعضهم بأنّ الأوضاع في العراق عموماً لا تبعث على الشعور بالطمأنينة، وبأن التجربة المريرة التي عاشوها قد تتكرّر في ضوء الصراعات الحاليّة والصفقات السياسيّة والتجاذبات الطائفيّة.
وبالعودة إلى تلك السنين، يمكن القول إنّ تبلور سياسة التنظيم القمعيّة التي سرعان ما لاحت بوادرها، جعل الأهالي يكوّنون صورة واضحة عن ماهيّة “داعش”، وهو ما قاد إلى ولادة بذور مقاومة نمت واتّخذت أنماطاً عديدة، فرديّة ومنظّمة، علنيّة وسريّة، بوسائل تعبير سلمية أو سواها.
أغلب تلك المحاولات، التي نستعرض جزءاً منها في هذا الفصل، باءت بالفشل وكانت نتيجتها الموت بطرق قاسية، وذلك مقابل حالات نجاة محدودة. لكن وسط كل تلك التجارب القهريّة، ومع إمعان التنظيم في الوحشيّة، وتكثيف الرسائل الدمويّة، واصل الأهالي محاولات النجاة والتحدّي حتى اليوم الأخير من تواجده.
الـ “م”: كتائب المقاومة

اعتبرت “وثيقة المدينة” التي أصدرها التنظيم في 13 حزيران/يونيو العام 2014، أنّ العمل مع الحكومة وفي صفوف الجيش والشرطة العراقيّة “عَمالةٌ ورِدَّةٌ يُقْتَل أصحابها”، لكنه استدرك أنّ “باب التوبة مفتوح لمن يريدها فقد خصصنا أماكن خاصة لاستقبال التائبين”. وبفتح باب الاستتابة هذا، هدف إلى إبقاء عناصر الجيش والأمن السابقين تحت مراقبته، أو الاستفادة من خبراتهم لتأسيس أجهزته الأمنيّة والعسكريّة، تمهيداً لإقامة “دولة الخلافة في الشام والعراق”. بدا ذلك واضحاً في أوّل خطاب ألقاه زعيم التنظيم في حينه، أبو بكر البغدادي، عندما اعتلى منبر الجامع النوري في الموصل، في الخامس من تموز/يوليو العام 2014، لِيُعلن تنصيب نفسه خليفة للمسلمين، طالباً من الأهالي “طاعته” ومهدِّداً مَنْ لا يستجيب.
يروي النقيب في الجيش العراقي السابق، حمزة ياسين، لـ “متحف سجون داعش” عن الحالة التي عاشها عناصر الأمن والجيش مع بداية سيطرة “داعش” على الموصل، فيقول “أقيمت مراكز الاستتابة في عدد من جوامع مدينة الموصل مثل جامع عمر الأسود، في منطقة شهر سُوق، وسط المدينة القديمة، وفُرِض علينا، نحن المنتسبين إلى الجيش والأجهزة الأمنية، أن نقصد تلك المراكز، لملء استمارة خاصة أُعدَّت لهذا الغرض، على أن يُسلِّم كل واحد منا سلاحه، وقد شهدت هذه المراكز إقبال أعداد كبيرة من ضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية”.
لكنّ ذلك، بالرغم من التوبة التي أعلنوها، لم يشفع لهم، فقد نكث التنظيم بوعد الأمان عندما بدأت الهجمات تستهدف عناصره، وقد سُجِّل في الأيام التي تلت أيلول\سبتمبر العام 2014، ظهور حرف “م” على بعض الجدران، في إشارة إلى “خلية مقاومة” ضد التنظيم الجاثم على صدر المدينة، ما يعني أنّ هناك معارضة قد بدأت تتشكّل وتتحرك.
التقينا ع.س. أحد عناصر خلية المقاومة، وكان ضابطاً برتبة نقيب في الجيش العراقيّ، وقد نجح في التخفّي والإفلات من الاعتقال، بخلاف آخرين عاملين ضمن الخليّة.
يقول ع. س. “كنا، نحن المسؤولين عن كتابة حرف (م) على الجدران، نحاول أن نربك التنظيم، ونبثّ الرعب في نفوس عناصره، ونبعث برسالة إلى أهلنا في نينوى تدفعهم إلى التمسك بالأمل”، ويتابع، “لكن داعش، وبفعل أساليبه العنيفة في التحقيقات، تمكّن من الحصول على أسماء وعناوين 14 ضابطاً كانوا يشكلون جزءاً من خلية المقاومة، فاعتقلهم ووجّه إليهم تهمة الردّة عن الإسلام والتجسس لحساب الأجهزة الأمنية في بغداد”.
وفي سجون “داعش” الأمنيّة كان مصير من يواجه تهمة الرّدة أو التجسّس القتل أو التغييب، وهو ما حدث لشقيق أحد الشهود الذين قابلناهم (فضل عدم نشر اسمه واسم شقيقه لاعتبارات أمنيّة). روى لنا الشاهد جانباً من قصة خلية المقاومة، “الخلية مؤلفة من مجموعة ضباط في الجيش والأجهزة الأمنيّة الحكوميّة، آثروا البقاء في الموصل بعد سقوطها، لأنهم من أبناء المدينة، بخلاف آخرين آثروا الفرار إلى مدن عراقيّة أخرى”.
وبحسب الشاهد، “تركّزت نشاطات هذه الخلية، في الكتابة على الجدران للتأكيد على وجود مقاومة، وتذخير بعض الأجهزة الأمنيّة بمعلومات وبيانات ومشاهد مصوّرة عن تحرّكات عناصر التنظيم ومقراته، وهو ما لعب دوراً في عمليات كسر التنظيم أثناء المعارك التي أدّت إلى طرده من الموصل في العام 2017”.
فيما بعد تفكّكت الخلية بسبب اعتقال وقتل الكثير من أعضائها، ونتيجة ذلك بدأت حركة هروب أعدادٍ من المنتسبين السابقين في قوّات الأمن والجيش، إلى مدن إقليم كردستان العراق، ومن لم يستطع الهرب عمد إلى تغيير مكان سكنه أكثر من مرة، لتفادي المصير المحتوم، أي القتل، في حال أُلقِي القبضُ عليه.
يقول النقيب السابق، حمزة ياسين، إنّه تمكن من الهرب مع عائلته إلى أربيل، ويتابع، “جاري وصديقي، العميد صالح العبيدي، نجح هو الآخر في الهرب إلى أربيل أيضاً، لكنه ارتكب خطأ كبيراً بالعودة إلى الموصل بعد أن تلقى تطمينات من قيادي في داعش بضمان سلامته، فقد خُطِف عند عودته، وحتى اللحظة لا تملك عائلته أيّ معلومة عن مصيره”.
في منتصف شهر آب/أغسطس العام 2016، نشر التنظيم أربعة إصدارات مرئية، تضمّنت مشاهد عن أربع طرائق طُبِّقت في عملية إعدام أفراد خلية المقاومة الذين اعتقلتهم: قطع الرؤوس والحرق والتفجير والإغراق، وقد أراد بذلك توجيه رسالة وحشيّة مفادها أنّ التمرّد مصيره الموت.
“عين الموصل”: خصم إصدارات “داعش”

وظف “داعش” نظامه الإعلاميّ المرتكز على “الإصدارات” المرئيّة، ليزرع الأوهام حوله والارتعاب منه، معتمداً تقنيات تصوير مدروسة، تبيِّن حجم الإجرام الممارَس من خلال بث مشاهد القتل بطرق متنوِّعة، ومنها الحرق أو قطع الرؤوس. في المقابل منع التنظيم أي نشاط إعلاميّ في مناطق سيطرته، واعتقل الإعلاميين والناشطين الصحافيّين، وغيّب العشرات منهم.
وبحسب تقرير نشره “مرصد الحريّات الصحفيّة العراقي”، فإن “داعش” توعّد كل من ينقل المعلومات والأنباء من داخل المدينة “بمواجهة الموت”، وذلك بموجب توجيهات “المحكمة الشرعية” التي وجهت إلى الصحافيّين اتهامات بمخالفة التعليمات وممارسة العمل الصحافيّ وتسريب معلومات من داخل المدينة إلى وسائل إعلام محلية وأجنبيّة.
وممّا ورد في التقرير نفسه أنّ التنظيم تمكّن من السيطرة على ثماني مؤسّسات إعلاميّة، إذاعية وتلفزيونية، بكامل أجهزتها ومعدّاتها، واستغلّ تقنياتها الحديثة لتصوير الظهور الأول لزعيمهم، أبو بكر البغدادي، بكاميرات قناة “سما الموصل” التي يملكها محافظ المدينة، أثيل النجيفي، فيما أطلق التنظيم إذاعة “البيان” وقناة “دابق” على تردّدات أرضيّة، مُستغلّاً بذلك معدّات وأدوات البثّ في مؤسسات شبكة الإعلام العراقي وفي مؤسّسات إعلاميّة أخرى.
في المقابل، لمواجهة ذلك كلّه، أُنشِئت صفحة على “فيس بوك”، في أعقاب سيطرة التنظيم على المدينة، باسم “عين الموصل”، نجحت في كسب الرأي العام، على اعتبار أنها الوسيلة شبه الوحيدة لتوثيق جرائم “داعش” ونقلها إلى الجمهور العربي والغربي على حدِّ سواء، إذ كانت تنشر المعلومات والأخبار باللغتين العربيّة والإنكليزيّة.
وثَّقت هذه الصفحة، التي أزيلت لاحقاً عن “فيس بوك” بعد أن حُفِظ أرشيفها في مدوّنة إلكترونية، الحياةَ اليومية في ظل سيطرة تنظيم الدولة، وممارسات عناصر التنظيم القمعيّة، والقيود المفروضة على حرية المرأة في التحرّك، وقيم الضرائب التي تفرضها على المواطنين، والطريقة التي تسيطر بها على المصانع ومعامل تكرير النفط، وعواقب الهجمات الجوية الأمريكية. كما نشرت مشاهد عن أعمال رجم مَنْ يُزعم أنهم ارتكبوا الزنا، وعن إلقاء رجال من مباني شاهقة بعد اتّهامهم بالشّذوذ الجنسيّ، وعن غيرها من أحكام الإعدام التي تنفذ على الملأ ناهيك من بثّ أخبار أعمال القتل السرّية. كما نشرت معلومات عن أشكال المقاومة التي مارسها سكان الموصل.
كما سَلّطت الصفحة الضوءَ على مواقف أهالي المدينة من “داعش”، وعبّرت عن تساؤلاتهم وآرائهم، وذلك في مقابلات أجرتها مع مدنيّين تكتّمَتْ على هوياتهم. كما أنّها تحدّثت عن معالم المقاومة المدنيّة في الموصل. ففي شباط/فبراير العام 2015، أفادت بأنّ بعض سكان المدينة رفضوا أن يلتحق أبناؤهم بالمدارس والجامعات، وأن بعض الآباء منعوا بناتهم من الذهاب إلى المدرسة حيث سيكُنَّ “تحت سيطرة العناصر الهمجيّين”، ومن دلائل المقاومة التي ذكرتها الصفحة، أنّ بعض سكان الموصل “لم يعودوا يجدون صعوبة في الحصول على سجائرهم” في تحدٍّ صارخ للتنظيم الذي جَرَّم التدخين وتجارة التبغ.
وفي العام 2015، وثّقَت صفحة “عين الموصل”، في شهر أيلول/سبتمبر وحده، 455 ، عملية إعدام، محدِّدةً مواقع الضحايا وأعراقهم ودياناتهم. كما نشرت معلومات عن العشرات من مقاتلي داعش الذين قُتِلوا في أعمال القصف التي استهدف بها التحالف الدوليّ قوافلهم العسكرية ومخازن ذخيرتهم. ثمّ إنّها نشرت صوراً لعناصر قالت إنهم “مشتبَه بهم رئيسيّون” و”مطلوبون لارتكابهم جرائم حرب ضد شعب الموصل”.
وقد أكّد مؤسّس الصفحة، عمر محمد، في حوار صحافي أجري معه العام 2016، أنه عمل على توثيق كل ما رآه في المدينة، ليس فقط عن “داعش” بل عن الناس وديناميكياتهم وحياتهم اليومية، وأضاف “كنت أذهب إلى الأسواق وأختلط بالناس، وبعناصر التنظيم أيضًا. دخلت معهم في عدة مناقشات وجادلتهم، كانوا ينصتون إلي، وخصوصاً عندما التقيت مجموعةً منهم في الأسواق القديمة. كنت أتحدّث معهم عن الشريعة الإسلامية بطريقة تأسرهم، بسبب معرفتي بالإسلام، ويُعلِّقون على ذلك بالقول: “ما شاء الله!”.
ومما يُذكَر هو أنّ عمر محمد عبّر مراراً عن مخاوفه. وأكّد أنّ الموصل كانت تعيش في ظلّ الخوف إبّان سيطرة التنظيم، إذ صار ” يُربّى الأولاد والمراهقون (من المنتسبين المغرَّر بهم إلى التنظيم أو من أبناء المنتسبين) على العنف، بحيث أصبحوا أهم مصدر لنمو التطرف في المنطقة”. وقال في مقابلة صحافية أجريت معه العام 2015، “إن أهالي الموصل لا يستطيعون الوثوق بأي شخص، ولا حتى بأفراد أسرهم في بعض الحالات. هنالك دولة خوف، تماماً كما كان في عهد صدام حسين. الناس ينظرون إلى داعش على أنها كيان وحشي ومروع يفرض قوانين قاسية”.
لاحقاً، وفي أواخر العام 2015 غادر مؤسس الصفحة الموصل، وبعد وصوله إلى أوروبا واصل عمله عبر “عين الموصل” بمساعدة أهله وأصدقائه الذين تواصل معهم عبر وسائل آمنة لتوثيق جرائم “داعش”.
اعتُمِدَتْ “عين الموصل” كمصدرِ أخبارٍ مهم من داخل الموصل في فترة الحرب ضد “داعش”، وهي وثّقت ضربات التحالف والقوات العراقية، وتحركات عناصر التنظيم، وبعد تحرير الموصل، كشف مؤسّسها عن هويته، معتبراً أنه “هزم داعش”.
نجا عمر محمد، على عكس غيره من الصحافيين، إذ أعدم التنظيم العشرات منهم، بتهمة “الخيانة والتجسس”، وفي خلال عامٍ ونصف بعد سيطرته على الموصل اختطف 48 صحافياً ومساعداً إعلامياً وطالب إعلام، وحتى تاريخ إعداد هذا التحقيق، ما زال كثيرون منهم في عداد المفقودين.
إعدام الصوت: نضال سميرة النعيمي

اشتُهرت سميرة علي صالح النعيمي، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، بين أهالي الموصل، منذ ما قبل سيطرة “داعش” بسنوات. فقد عُرفت الحقوقية الخمسينية، حسب شهادات كثيرٍ من السكان، بمواقفها التي وُصفت بـ”الشُجاعة زمن الرعب”، ولاحقاً، بعد سيطرة التنظيم على الحياة في المدينة، كان صوت النعيمي من الأصوات القليلة المرتفعة في انتقاده والتعبير عن رفضه.
ولدت النعيمي العام 1963، تعلّمت القراءة والكتابة في مدارس محو الأمية، ثم أكملت تعليمها ودخلت كلية الآداب قسم التاريخ، قبل أن تواصل دراستها في القانون.
عُرفتْ سميرة النعيمي، وهي أمٌ لابنٍ وابنة متزوّجين، بنشاطها في الشأن العام، إذ كانت عارضت الوجود الأمريكي في العراق، وتولّت مهمة المُرافعة في المحاكم، دفاعاً عن المعتقلين في السجون الأمريكية والعراقية، فضلًا عن نشاطها في مساعدة الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
في العام 2011 شاركت مع ناشطين من مدينتها في تنظيم اعتصاٍم شعبيّ، لمطالبة حكومة بغداد بالإفراج عن المعتقلين من أبناء المدينة، وخصوصاً النساء. وكانت قد استثمرت صفحتها على موقع “فايسبوك”، كمنصةٍ لإطلاق مواقفها من الأوضاع في العراق، وخصوصاً في مدينتها الموصل.
وقد بلغت ذروة سخطها على “داعش”، بعد تفجير عناصره جامع النبي يونس، في 24 تموز/يوليو العام 2024، فهاجمت التنظيم على حسابها، وكتبت: “يسقط أبو جهل البغدادي العميل الصهيوني”. في إشارة إلى زعيم “داعش”. كما يروي ابنها سالم محمد أمين أن والدته نزلت بعد أيام من تفجير جامع النبي يونس “في وضح النهار، تحمل بيدها قطعة فحم كتبت بها على جدار معمل الغزل والنسيج الواقع في حي المنصور، عبارات ضد التنظيم وزعيمه أبو بكر البغدادي”.
وبعد ذلك استقلَّت سيارتها وتوجهت إلى المدرسة في الحيّ نفسه، لتكتب العبارات نفسهاعلى جدارها، فتعقّبها مسلَّحو التنظيم، وبعد ساعات داهموا بيت ابنتها حيث كانت واعتقلوها.
تباينت الروايات حول تاريخ اعتقال التنظيم الحقوقيّة النعيمي، ولكنّ المؤكد أنها خضعت للتحقيق والتعذيب في سبتمبر/أيلول العام 2014. وفي صبيحة الثاني والعشرين منه، اقتيدت إلى ساحة باب الطوب في وسط الموصل بالقرب من مبنى المحافظة، حيث أعدمها مسلَّحو “داعش” رمياً بالرصاص، ثم سُلِّمتْ جثّتها إلى مشرحة الطب العدلي. وقد أبلغ التنظيم عائلتها بإمكانية تسلّم جثمانها من هناك في اليوم التالي، فيما أكد أحد أقارب العائلة، أن الأمر صدرَ بمنع إقامة مجلس عزاء لها.
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان المتحدث باسم الخارجية، جينفر ساكي، إعدام النعيمي، فيما أصدر رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى العراق نيكولاي ملادينوف، بياناً اعتبر فيه أن “عملية الإعدام العلني للمحامية المعروفة والناشطة في مجال حقوق الإنسان سميرة صالح النعيمي، ما هي إلاَّ جريمة أخرى من الجرائم البغيضة التي لا تُحصى، والتي ارتكبها داعش بحق الشعب العراقيّ، وأن داعش يستهدف دائماً الضعفاء والعزّل في عمليات وحشيّة وجبانة تفوق الوصف، متسبباً بمعاناة لا يمكن تبريرها لجميع العراقيين بغض النظر عن جنسهم وأعمارهم وطائفتهم ومعتقدهم”.
وفي تصريح لـصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنيّة أكدت المحامية وعضوة البرلمان العراقي عن محافظة نينوى انتصار الجبوري، وهي زميلة لسميرة النعيمي، أن “تنفيذ حكم الإعدام بالناشطة والسياسية والزميلة العزيزة الشهيدة سميرة النعيمي على يد داعش هو عمل في غاية الخطورة، ويُضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها التنظيم ضد الجميع، سواء كانوا نساء أو رجالاً”.
الحياة ثمن المبدأ العلمي: مُدَرِّسة ثانوية الزهور
فرض التنظيم، بعد أربعة أشهر من إخضاعه الموصل، أي في تشرين الأول/أكتوبر العام 2014، تعليمات جديدة فيما يخص مناهج التعليم في المدارس، ومنها ما قضى بإلغاء بعض المواد العلميّة في مختلف المراحل التعليميّة، من الابتدائية وحتى الجامعة. كما أعلن أن “العام الحالي هو عام نهاية العمل بالمناهج القديمة”، وشطب عبارة الجمهورية العراقية والأناشيد الوطنية والقصائد الشعرية، وغّيّرَ المسميات التعليمية، مثل ديوان التعليم بدلاً من وزارة التربية، والإعداد الجهادي البدني بدلاً من التربية الرياضية، والتربية الجهادية، والسياسة الشرعية، بدلاً من التربية الوطنية، والصف الأول الشرعيّ بدلاً من الأول الابتدائي.
آثر بعض السكان عدم إرسال أبنائهم للتعلُّم في مدارس التنظيم، كما انقطع بعض طلاب الجامعات عن الحضور في كلياتهم، أما المعلِّمون فكان لزاماً عليهم تدريس الطلاب مناهج التنظيم الدخيلة.
وبحسب شهادات عدد من السكان، فإنّ أشواق النعيمي، المُعلمة في ثانوية “الزهور” في الموصل، رفضت ما فرضه “داعش” من مناهج وتعليمات جديدة بعد سيطرته على الموصل، ونظَّمت زيارات لأهالي الطلبة لحثّهم على عدم إرسال أولادهم إلى المدارس.
استدعى التنظيم المعلمة للتحقيق، وهدّدها بالقتل إذا لم تستجب للتعليمات التي أصدرها، لكنّها أصرت على موقفها إلى أن اعتقلت من منزلها.
تقول زميلتها سوسن صالح إنّ “ما يميزها هو أنها كانت تتمسّك بقناعاتها عندما يحضر عناصر من (داعش)، ويحاولون أن يُملوا عليها تعليماتهم بخصوص بعض المفردات والموضوعات وضرورة عدم التركيز عليها إلى أن يجري استبدالها، لكنها كانت ترفض”.
في 10 كانون الأول/ديسمبر العام 2015، أعدم “داعش” أشواق النعيمي، رمياً بالرصاص وسط مدينة الموصل، ومنع التنظيم أسرتها من إقامة مراسم العزاء، واقتصر المعزّون على أفراد العائلة فقط، حسبما أكدته إحدى زميلاتها اللاتي التقاهنّ “متحف سجون داعش”.
تقول زميلة المُدَرِّسة النعيمي: “ضرب داعش أمثلة على مدى قسوته ضد من يقف في وجهه، فطالت الإعدامات عشرات الموصليين، بينهم أطباء ومحامون ومدرسون وموظفون وعسكريون وشرطة، لذا لم يتجرأ زملاء النعيمي ولا معارفها ولا الجيران على حضور مراسِم الدفن وتقديم واجب العزاء لأهلها، خشية أن يضعوا أنفسهم في موقف المغضوب عليهم”.
راية داعش في الأرض: بدلة برتقالية بجانب العلم العراقي

بلغت انتهاكات التنظيم، في غضون سنتين من سيطرته على الموصل، “حدّاً مذهلاً” بحسب وصف المفوّض السامي السابق لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، في التقرير الذي نشرته المفوضية العام 2016، والذي ورد فيه أيضاً أن التنظيم أجبر أولاداً في الموصل على تنفيذ أحكام الإعدام، وواظب على انتهاج طرق وحشية في عمليّات القتل الجماعي، كما تفاقمت معاناة النساء، وبدأت المقابر الجماعية بالتكشّف في مناطق مختلفة من محافظة نينوى.
كان الخوف بين المدنيين على أشده، مع استمرار أساليب “داعش” وتعليماته في تقييد وتقنين الممارسات الدينية والحريات والعادات الشخصية، وكان من المنطقي أن تأخذ المواجهة بينه وبينهم، في سعيها للتعبير عن نفسها، شكل تحركات سرّية فردية في عدّة حالات.
فمثلاً، علي عيد خلف الجميلي، وهو شاب لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره، من قضاء الشرقاط جنوب محافظة نينوى، آثر مواجهة “داعش” بطريقة مُختلفة.
يتذكَّر والد الجميلي بتأثر قصة ابنه: ” في إحدى الليالي خرج ولدي من دون أن يعلم به أحد من أفراد البيت، إلى منطقة خلاء يرتفع فيها برج عالٍ للاتصالات وسط قضاء الشرقاط. لا أعرف كيف استطاع أن يتفادى عيون داعش، لأنهم يتواجدون في عدد من نقاط المراقبة، إضافة إلى دورياتهم الراجلة”.
ويُضيف الوالد في شهادته لـ”متحف سجون داعش”، أنه استفاق في اليوم التالي على خبر إسقاط راية “داعش” ورفع العلم العراقي، “كان الحديث يدور همساً بين سكان القضاء، بينما توزعت مشاعرهم متأرجحة بين الفرح والخوف، شعروا بأن شيئاً ما يحدث في السّر يشي بظهور مقاومة، لكنهم في الوقت ذاته أدركوا أن هذا الحدث ستكون نتائجه وخيمة عليهم جميعاً، وأن الساعات القادمة ستشهد اعتقالات وتحقيقات وترهيباً”. وهذا ما حدث فعلاً، إذ اعتقل على أثر الحادثة العديد من شبان القضاء بشكل عشوائي، وخضعوا لسلسلة تحقيقات تعرضوا فيها للضرب العنيف.
يقول الأب: “لم يخطر في بالي أن ابني هو من قام بهذا العمل. لم أسمعه يوماً يتوعّد داعش، لهذا لم يساورني القلق عليه عندما اعتقل مع بقية الشبان. وبالفعل أطلق سراحه بعد يومين، لكنهم عادوا بعد أربعة أيام، واقتحموا البيت وسحلوه، أي جرّوه أرضاً، حتى السيارة التي كانت تنتظرهم”.
لاحقاً اعترف علي بمسؤوليته عن إسقاط “راية التنظيم”. وفي 29 كانون الثاني\يناير 2016، واجه والده مشهد إعدامه، “ارتعدت عندما شاهدت ولدي يرتدي البدلة ذات اللون البرتقالي. وهنت قواي، حاولت أن أتمالك نفسي، خاطبت الله أن يلطف بي وبابني. أرغموه على صعود البرج، كانوا قد ربطوا آلة تصوير على جبهته، الجميع أخذ يراقبه حتى وصل إلى القمة، كانت أوامرهم أن ينزل العلم العراقي الذي كان قد رفعه بنفسه، ويستبدله براية داعش السوداء، إمعاناً في إذلاله”.
استمرّ علي في المقاومة حتى آخر رمق، إذ مزّق راية “داعش” مجدّداً ولوَّح بالعلم العراقي، فتلقى رصاصة قاتلة في صدره أفقدته القدرة على الوقوف. يقول والده: “في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل استطعت الوصول إلى جثته، وجدته مذبوحاً تحت البرج. لم يتجرأ أحد على الوصول إليه خوفاً من أن تطاله عقوبة الإعدام”.
لاحقت تبعات القضية عائلة علي كلها، إذ اتُّهم أفرادها بـ “الردّة”، ومنع الناس من التواصل معهم، كما عاملوا والدته بقسوة، وضربوا الأولاد، وفجَّروا المنزل.
المقاومة بدافع الثأر: عنصران من داعش مقابل مدنيّ
دفعت مدينة الموصل ثمناً كبيراً لرفض “داعش” ومواجهته، إذ شهدت إعدام الآلاف من سكان المدينة، ممن اعتقلهم بتهمٍ مختلفة. يستذكر السكان مثلاً، تاريخ الرابع من آب/ أغسطس العام 2015، عندما عّلقَ التنظيم على جدار مبنى الطب العدلي، قوائم فيها أسماء 2072 شخصاً أُعدِموا، ولم تُسلم جثامينهم إلى ذويهم، ومن المُرجح أنها أُلقيت في حفرة كبيرة تُسمى الخسفة، وتقع على بعد عشرين كيلومتراً جنوب مدينة الموصل، على طريق بغداد، وقد حوّلها التنظيم مقبرة جماعية بين العامَيْن 2014 و 2017.
وقد كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير أصدرته في 22 آذار/ مارس 2017، أنّ 25 ألف شخص ممن أعدمهم “داعش” رميت جثثهم في الخسفة.
إنّ عمليات الإعدام التي طالت المئات من سكان الموصل ومن شرائح مختلفة، قد خلفت وراءها جروحاً عميقة في نفوس السكان عموماً، وكان من الطبيعي أن تتولد مشاعر الكراهية ضد عناصر التنظيم، والبعض كان ينتهز أي فرصة مناسبة لكي ينتقم. من بين هؤلاء ن. أ، الذي ثار على طريقته، ثأراً لمقتل أخيه على يد “داعش”.
التقينا ن. أ. في الموصل، فروى لنا كيف انتقم لمقتل أخيه الذي كان مُعتَقلاً في أحد سجون التنظيم: “في مساء أحد الأيام طرق باب بيتنا أربعة عناصر من داعش، وطلبوا من أخي الأكبر الذي كان يعمل سابقاَ في مفوضية الانتخابات، أن يرافقهم إلى مقرّ التنظيم في منطقة حيّ العامل حيث نسكن لتدوين أقواله حول طبيعة عمله السابق”.
يتابع ن. أ. “في الحقيقة لم أثق بهم منذ لحظة دخولهم الموصل، وفي الوقت نفسه لم أكن راضياً أبداً عن ممارسات الجيش والقوى الأمنية قبل سقوط مدينتي. قررت مرافقة أخي إلى المقرّ لكي أطمئن، لكنهم أبلغوني في المقر إن إجراءات التحقيق معه لن تستمر أكثر من يومين”.
كانت فترة الانتظار غاية في الصعوبة، أربكت العائلة التي عاشت في قلق على ابنها المعتقل، والذي كان يتحضر قبل ذلك للزواج. لكن نهاية هذين اليومين كانت أسوأ مما توقّع الجميع. يقول ن. أ. “ذهبت إلى المقر، فاقتادني أحد الحراس إلى شخص آخر. وقفت أمامه وكان ينظر نحوي بعينين تملؤهما القسوة، وقبل أن يمنحني فرصة السؤال عن أخي، رفع سبابة يده اليمنى بوجهي وأخذ يهزّها وهو يخاطبني مهدداً بلغة عربية فصيحة عن المصير الأسود الذي ينتظر الكافرين والخارجين عن ملّة الإسلام، وبجملة سريعة خاطفة طلب مني أن أذهب إلى الطب العدلي لاستلام جثة أخي، محذراً من إقامة مراسم العزاء”.
قرر ن.أ. الانتقام “مهما كانت النتائج، فالمسألة أصبحت ثأراً شخصياً”، يروي لنا تفاصيل العملية التي انتهت بقتل عنصرين من التنظيم، وبنجاته. “كنت عائداً في أحد الأيام من دكان البقالة الصغير الذي أملكه في منطقة الموصل الجديدة، لاحظت وجود مفرزة لداعش مؤلفة من عنصرين يقفان في أحد الشوارع، وفي لحظة خاطفة لم تأخذ مني سوى ثوانٍ، قررت انتهاز الفرصة لتنفيذ قَسَم الانتقام”. صدم ن.أ. العنصرين بسيارته، بعد التأكد من خلو الشارع وعدم وجود شهود، “سقطا على الأرض، نزلت من السيارة لأتأكد من عدم قدرتهما على النهوض والحركة، انتزعت مسدس أحدهما وأطلقت عدة رصاصات على رأسيهما”.
حكايات من الموصل القديمة: تحدّي ساحات الإعدام

حول التنظيم الأماكن العامة التي تشهد ازدحاماً في الموصل إلى مراكز لتنفيذ الإعدامات، ومنها على سبيل المثال: ساحة باب الطوب وسط الموصل، منطقة الدواسة، الفيصلية، حي النجار، منطقة خزرج، منطقة رأس الجادة ، حي الوحدة ، دورة اليرموك، حي الإصلاح الزراعي، إضافة إلى أعمدة الجسور الخمسة في المدينة.
في سوق الحدادين التاريخي، بالقرب من جسر الموصل العتيق، التقينا محمد شاكر، الذي يملك دكان حدادة. تحدث محمد عن مشاهداته في المكان في زمن سيطرة التنظيم، “أذكر أنني شاهدت ثلاث جثث معلقة من الأقدام أسفل سياج “جسر الحرية”، كانت الرؤوس متدلية باتجاه مياه النهر، بقيت على هذا الحال فترة طويلة إلى أن تعفنت وجفَّت، إلى أن انتهت إلى هياكل عظمية “.
ويضيف: “رأيت مثل هذا المشهد مرة أخرى عند مقدمة الجسر العتيق، الذي لا يبعد عن دكَّاني سوى بضعة أمتار، كان هناك جثتان معلقتان في أوّل الجسر على جانبيه، وما علق في ذاكرتي هو أنّ أحشاء إحدى الجثتين كانت متدلية إلى الأسفل، ما أثار شهية الكلاب لنهشها” .
في حزيران/ يونيو العام 2015، أكّد الطبّ العدلي في المدينة أن أعلى نسبة قتل سُجِّلت في سوق باب الطوب الذي حوله التنظيم من أكبر سوق لأهالي الموصل وبقية الأقضية والنواحي والقرى إلى مكان لإعدام المئات من الناس. ومن هؤلاء خمسة شبانٍ يعملون في محل لبيع العصائر يدعى “صباح أبو الشربت” الشهير في منطقة باب الطوب، وقد أعدمهم “داعش” بعد إلقاء القبض عليهم، بتهمة التخابر مع الأجهزة الأمنيّة العراقيّة.
وقد التقينا في المدينة عماد، وهو في الخمسينات من عمره، ووالد أحد الشبّان الخمسة، عُمَر الذي اعتُقل ليلة 27 تموز/ يوليو 2016، بتهمة “التجسس والتواصل عبر الهاتف مع المرتدّين الكفرة من أجهزة الأمن في بغداد”، بحسب ما أخبره العناصر.
علم أبو عمر أن ابنه اعتقل مع زملائه العاملين في محل العصائر، “بعد مضي أسبوعين على اعتقاله تناهى إليّ أنّ سبب اعتقال الشبان الخمسة هو أن عنصراً روسياً من داعش، كان يتردّد على محل الشربت، وصادف في يوم اعتقالهم أن تسوّق من المحل وغادر قبل أن تستهدفه طائرة مسيرة بصاروخ بالقرب من مبنى المستشفى العام، فقتل هو ومن كان معه داخل السيارة”.
اتهم الشبان الخمسة بتسريب المعلومات عن العنصر، بعد أن وجدت آثار العصير في السيارة. تقول والدة عمر، التي شاركت زوجها شهادته عن تلك الحادثة، “بقي ابني مع رفاقه رهن الاعتقال والتحقيق 76 يوماً، وبحسب ما بلغَنا من أخبار، فقد تعرض للتعذيب بأساليب وحشية. بقيتُ طيلة فترة اعتقاله أقف ساعات طويلة في الليل والنهار عند الباب أنتظر عودته، إلى أن جاء ذلك اليوم المشؤوم عندما سمعنا عن عملية إعدام ستجري عند محل الشربت”.
شهد أبو عمر، مع حفيده، ابن عمر، عملية الإعدام أمام محل العصائر الذي كان يعمل فيه، وقد روى بحرقة كيف توسل الطفل العناصر كيلا يعدموا والده، لكن “قضي الأمر، وفي لحظة خاطفة، سقط الشبان على الأرض مضرجين بدمائهم، لاحظت أن وضعية ولدي كانت أقرب إلى حالة السجود… تقدم عنصر خطوة باتجاهه، ركلَ جثته بقدمه فمالت جانباً وطُرحت على الأرض”. حمل العناصر الجثث بعد ذلك في سيارة إلى مكان مجهول، ولم تتمكن العائلة من دفن ابنها أو معرفة مكان قبره.
يستدرك أبو عمر، “علمت لاحقاً أن ابني وبقية الشبان كانوا ضمن كتائب المقاومة (م)، وإلى يوم اعتقالهم كانوا على تواصل مستمرّ مع الأجهزة الأمنية العراقية”.
صورت مجموعة صباح أبو الشربت، قبل إعدام أفرادها، مقاطع فيديو تحت عنوان “بشائر النصر” تضمّنت لقطات تظهر فيها مقرات “داعش” داخل الموصل، كما تضمّنت المقاطع لقطات من نشاطهم السري وهم يكتبون على الجدران حرف (م)، رمز المقاومة، وكذلك توزيعهم مساعدات غذائية بشكل سرّي لدعم العوائل المحتاجة عندما اشتد الحصار على الموصل ونال الجوع من سكانها.
في الأحياء القديمة، على الجانب الأيمن من الموصل، التي نالت نصيباً واسعاً من العنف والدمار، سمعنا قصصاً كثيرة عن أشخاص تحدّوا التنظيم على طريقتهم، وانتقدوه. روى لنا حلاق ثلاثينيّ، يسكن منطقة الدواسة، كيف عُذِّب شابان وأُعْدِما بعد أن ظهرا في مقطع فيديو في حالة سكر، علماً أنّ التنظيم منع بشكل باتٍّ شرب الكحوليات. يقول الحلاق “لم يتوقف تحدّي الشابين عند هذا الحد، بل كانا يسخران في مقطع الفيديو من أبو بكر البغدادي، فيما هما يتبادلان نُكاتاً تحط من شأنه وتستهزئ به”.
المقاومة كمشروع ثقافي
في 10 كانون الأول/ديسمبر العام 2017، تمكنت القوات العراقية من دخول مدينة الموصل وهزيمة التنظيم، إثر حملة عسكرية قادها التحالف الدولي، وشاركت فيها قوات من دول عدة. وقد قُتِل في تلك الحملة حوالى 11 ألف مدنيّ، بحسب تقديرات نقلتها وكالة “أسوشيتدبرس” بالاعتماد على بيانات الخسائر في الأرواح وتقارير المستشفيات وتقارير القتلى التي نشرتها منظمات مدنية وثّقت الغارات الجوية في العراق وسوريا.
إنّ ما أبدته المدينة من مقاومةٍ دفعت ثمنها باهظاً، جاء كمشروع شامل لا يُختزل بمواجهات مسلحة أو كتابات على الجدران، وكنمط قائم على التحدّي والثبات القيمي، بالرغم من سطوة التنظيم ووحشيته. بل إن المقاومة في الموصل كانت فعلاً واعياً من مجتمعٍ متضامن، ضدّ مشروع أيديولوجيّ قهريّ.
ليس هناك مؤشرات على أن جهاتٍ حزبية أو سياسية كانت وراء أعمال المقاومة، بالرغم من أنّ بعض الجهات في نينوى روَّج مثل هذه الإشاعات. ويمكن القول إن المقاومة في الموصل، باعتبارها مشروعاً ثقافياً مجتمعياً، لم تتوقف مع تحرير المدينة من سلطة “داعش”، بل تحوّلت إلى وسيلة فعالة وحيوية لتحقيق تطلّعات المجتمع الموصلي.
ومن يتابع اليوم حركة الحياة الثقافية وفاعليتها المجتمعية في مدينة الموصل، سيخرج بتصوّرات جديدة عما كانت عليه قبل 10 تموز/يوليو العام 2014، إذ تأسّس مؤخراً الكثير من منظّمات المجتمع المدني التي تهتم بإقامة المشاريع الثقافية، موليةً اهتماماً خاصّاً بموروث المدينة الثقافيّ والحضاريّ.